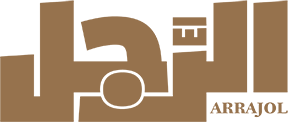الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.. رجل تغلّفه الأسرار






في أحد الأيام قال عبد العزيز بوتفليقة لواحد من زواره الأجانب: "أحب القذافي، لأنه لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفكر فيه"، إعجاب يستند إلى قناعة راسخة لدى ساكن قصر المرادية، مفادها أن السرية وعنصر المفاجئة أحد الأسس الرئيسة للتخطيط، حتى إن شقيقه سعيد بوتفليقة، الذي ينعت بعين "السلطان"، والقريب منه صباح مساء، لا يعرف نواياه الحقيقية، يقول مقرب عارف بخبايا القصر الرئاسي.
حين شاع خبر نقل عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري، إلى باريس في 27 ابريل/ نيسان 2013، لتلقي العلاج، وبعد أن شخّص الأطباء المرض، بات معه الكل من داخل دائرة قصر المرادية، يتنبئون بنهايته السياسة، بل منهم من كان في حوزته الاسم المرشح لخلافته، لكن صاحب العبارة الشهيرة بالعامية الجزائرية، "جيلي طاب جنانو وعرف من عاش قدره"، بما يفيد -أن عهد جيل الثورة التحريرية الذي لا يزال يحكم الجزائر قد انتهى-، سيخيب التوقعات، بإعلان ترشحه لعهدة رابعة، خاصة وأنه عبر في أكثر من مناسبة عن نية التنحي، وهو ما يجعل شخصية هذا الدبلوماسي المحنك تتسم بالالتباس والغموض، صفات ترسخت لديه في زمن العمل السري السياسي والعسكري إبان الثورة الجزائرية، وتطبع بها أثناء اشتغاله في السلك الدبلوماسي لما يفوق عن 20 سنة، كما أن معرفته بـ"خبايا" الجيش الذي ظل هو المحرك الفعلي للحياة السياسية خلال خمسة عقود من استقلال الجزائر، جعلته "لا يقبل بأن يكون ثلاث أرباع رئيس"، كما يقول، وفي لحظات اعتكافه عن الكلام علينا أن ننبش في صفحات غامضة من تاريخ الرجل، السياسية، الحياتية والشخصية،عائلية، زوجية، غرامية...
"الرجل" تعيد نشر جزء من حوار نادر مع الراحل سلطان بن عبد العزيز
المهارة السياسية
أنهك المرض، بوتفليقة، ولم تنهكه السياسة، فما دام يفكر، فهو موجود، لكن في ماذا يفكر؟ هذا ما لا يعرفه أحد سواه، ففي مناسبات ثلاث سيلمح إلى احتمال انسحابه من الحكم. المرة الأولى في 2007، عندما كلف شخصية سامية بالتفكير في المرحلة الانتقالية، وفي السياق ذاته ستقتني رئاسة الجمهورية عبر سفارتها في سويسرا إقامة كبيرة في جنيف مقابل 25 مليون أورو، لتكون منتجعا للرئيس المنسحب، غير أنه سرعان ما تخلى عن مشروع المرحلة الانتقالية. في شهر مارس/ أدار من سنة 2011 ، سيجتمع الرئيس الجزائري أسابيع قليلة بعد الربيع العربي، بإقامته الرئيسية، برئيس وزرائه والأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني" عبد العزيز بلخادم، وكذلك رئيسي غرفتي البرلمان. وقال لهم باختصار "قدموا لي دستورا جديدا يحد من الولايات الرئاسية ويقوي من صلاحيات الحكومة"، مضيفا "سأغادر الحكم".
وفي آخر إعلان لرئيس الجمهورية أمام آلاف الأشخاص بمدينة سطيف، عشية الانتخابات التشريعية، في شهر آيار/ مايو 2012، بأن مهمة جيل ثورة التحرير انتهت، بات العديد مقتنعين أن بوتفليقة يرغب فعلا في التنحي، مؤشرات جعلت البعض من داخل مؤسسات الدولة يطلون برؤسهم خاصة بعد مرض الرئيس، ليناقشوا بعض الخيارات الدستورية لسد الفراغ الممكن أن يحدثه استقالة الرئيس، أو إقالته لظروفه الصحية، كخلق منصب نائب الرئيس، أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، لكن الرئيس كان يترك لنفسه مساحة زمنية لاستكمال ترسانة من الإصلاحات، تتطلب منه انجازا تدريجيا يأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح، فرضت عليه مراجعة جذرية لأسلوب عمل بعض المؤسسات، بتحديد صلاحياتها الدستورية والقانونية، وهي عملية ليست بالهينة، وكما يقول، حين أردت أن أكون رئيسا للجمهورية كنت أعرف أنه تنتظرني جهنم، لكن الشعب الجزائري يستحق أن أذهب من أجله إلى جهنم"، "الجزائر تحتاج من يحبها كيفما هي فهي عروس كبيرة وليست بالسهلة وحبها يجلب دورانا في الرأس".
جاء عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئاسة، وهو مطوق بحب بلده، مقتنعا بأن يمارس أدواره كاملة، بعدما عايش عن بعد وعن قرب، تجربة إبعاده من طرف مؤسسة الجيش بعد وفاة الهواري بومدين. "يومها انتشرت في الجزائر نكتة سياسية تقول بأن الصراع حول الخلافة، دار بين شخصية معربة هي اليحياوي، وشخصية مفرنسة، هي عبد العزيز بوتفليقة، لكن الجيش الذي لا يحب التدخل في السياسة اختار ضابطا محايدا، هو الشاذلي بن جديد، الذي يجهل اللغة العربية ويجهل اللغة الفرنسية، ولا يفهم سوى "حاضر سيدي"... وواضح ما تشتمل عليه هذه النكتة من من غمز ولمز من تحت لقيادة الجيش.
وواقع الحال أن السيد عبد العزيز بوتفليقة يتقن العربية والفرنسية بنفس الدرجة، ويرتجل بهما خطابات سياسية تنم عن ثقافة واسعة، كما أن محمد الصالح اليحياوي لا يجهل اللغة الفرنسية، وإن كان تكوينه الثقافي عربيا خالصا.
وإبعاد الرجلين من حلبة الصراع حول الخلافة وتقديم الشاذلي بن جديد مرشحا وحيدا، كان أمرا قضي بليل، عبر مشاورات اقتصرت على صناع القرار داخل جهاز الاستخبارات والأمن العسكري الذي لم يتوقف عن توجيه دفة السياسة، إما في الظل خلال الأوضاع العادية، وإما علنا أثناء الأزمات.
من سخرية القدر، أن المؤسسة العسكرية سترضخ لطلبات بوتفليقة للعودة لإدارة البلاد، تحت ضغط الإنهاك والتهم والملاحقات التي لوّحت بها بعض الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية، ضد بعض الضباط والقيادات المتهمة من بعض الإسلاميين الجزائريين "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وارتكاب مجازر جماعية"، وذلك بهدف حماية رموزها من المتابعة والإزعاجات الدولية.. لينتخب في 15 أبريل/ نيسان 1999 رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتعود أولى اتصالات المؤسسة العسكرية مع الرئيس الحالي، عبدالعزيز بوتفليقة، إلى العام 1994، في ذروة الأزمة السياسية والأمنية، ولم يرض الرجل حينها بعرض المؤسسة العسكرية، لأن الهامش الذي وضع له آنذاك لم يقنعه ولم يرحه، وهو الشخصية النرجسية الطموحة، لفرض مشروعه وترك بصماته في البلاد التي غادرها شبه مطرود.
بوتفليقة والقطط السمان
كان بوتفليقة الرئيس الوحيد الذي انتقد في سنواته الأولى وعلى الملأ ما يعرف في الجزائر بـ"الجنرالات"، واتهمهم بالهيمنة على كل شيء واصفا إياهم بـ"القطط السمان"، كما قضى سنوات حكمه الأولى في ترتيب أوراق هيئة أركان الجيش والمخابرات.
استقلالية القرار
التجربة السياسية لـبوتفليقة السابقة عن مرحلة الرئاسة، وكذا تجربته العسكرية جعلته دائماً لا يثق بعقداء الجيش، وخاصة الفئة التي التحقت بالجيش الوطني الشعبي سنة 1958، ومن ضمنهم الضباط الذين اشتغلوا في القوات الفرنسية، دون أن يعني ذلك انحيازه التام إلى قادة الثورة العسكريين أو المدنيين؛ فالرجل كانت له مواقفه الخاصة ووجهة نظره في الشخصيات التي يدور في محيطها، أو تدور في محيطه. حين أراد بومدين وجهة نظر محمد بوضياف من مقترح تسلم الأخير للسلطة، بدعم من قيادة الأركان، أوفد إليه وإلى شخصيات أخرى ذارعه اليمنى، الذي لم يكن حينها متحمساً لهذا المقترح، لكون بوضياف من وجهة نظر بوتفليقة، حادّ الطبع وجافّ وجلف في تعامله مع العسكريين، ولم يكن هذا الموقف إلا مقدمة للدور الذي أسهم فيه العقيد بوتفليقة، فيما يعرف بأزمة صيــــف 1962، حين دخــــلت الحكومة المؤقتة التي كان يقودها بن يوسف بن خدة، في صراع مع قيادة الأركان العامة، التي يدعمها بن بلة، وانقسمت الجزائر إلي جناحين مجموعة تلمسان، وكانت تضم بن بلة وقيادة الأركان، فضلاً عن فرحات عباس، والمناطق العسكرية الأولى والخامسة والرابعة، ومن جهة ثانية مجموعة تيزي وزّو، وتحول الصراع إلي صدامات عسكرية أيام 3 و4 و5 سبتمبر، من عام 1962، وسقط قتلى بالمئات وأريقت الدماء.
يستشف من هذه الرواية، جانب السرية والتروي في الممارسة السياسية لعبد العزيز بوتفليقة، كما تشي هذه الواقعة بالكثير، هو أنها سترخي بظلالها على الحياة السياسية والعسكرية في الجزائر، التي قادها زعماء كل منهم كان يرى نفسه يمثل المشروعية التاريخية للثورة، وفي إطار هذا النزاع، سيجد بوتفليقة نفسه مهدداً بالإبعاد من دائرة حكومة بن بلة، الذي أراد أن يضمن لنفسه السلطة، بعيداً عن هيمنة العسكر، حينها فهم بومدين أنه هو المقصود من محاولة إبعاد بوتفليقة من وزارة الخارجية، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، بعد أن سارت العلاقة بين رئيس الأركان ورئيس الجمهورية إلى الأسوأ، ليبدأ في التخطيط لإزاحة بن بلة من الحكم، ونجح في تنفيذ المهمة يوم 19 حزيران / يونيو 1965، بمساعدة مجموعة مقربة منه سياسية وعسكرية، وكان على رأسهم طبعاً عبد العزيز بوتفليقة، وتم الانقلاب تحت شعار التصحيح الثوري.
في هذا السياق سيعتلي بوتفليقة منصب الخارجية الجزائرية، نسج من خلاله الكثير من العلاقات الشخصية، في العواصم الدولية والعربية، وفي هذا الزمن كانت أدوار المؤسسة العسكرية قد كبرت على حساب المؤسسات الأخرى، وترامت أطرافها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الأمنية، وسيغادر الرئيس بومدين إلى دار البقاء في 27 ديسمبر/ كانون الأول 1978، تاركاً للجيش اختيار الرقم الموائم له في معادلة اللعبة السياسية، وستحد من صدى كلمة الـتأبين التي سيلقيها بوتفليقة في حق رجل كان فاعلاً في حياته، تعبيراً منه عن إخلاص الأحياء للأموات، الرسالة الرمزية لبوتفليقة سيرد عليها الجيش بقراءة سياسية لا تخلو من إيحاء، ترجمته بتفضيلها الشاذلي بن جديد على عبد العزيز بوتفليقة في منصب الرئاسة، مع محاولة قتل رمزية له، تجسدت برفضه في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في ديسمبر 1981، ليختار الرجل المنفى نحو الخارج.
الوفاء لاصدقاء الدرب
بوتفليقة كان وفيا فعلا لرفيق دربه هواري بومدين، دون أن يعني ذلك السير على منواله السياسي، القائم على مشروع اشتراكي لم يفض إلى نتيجة، وهذا ما يشهد به خصومه السياسيين في ذلك العهد، كقاصدي مرباح رئيس وزراء سابق في عهد الشاذلي بن جديد ومدير المخابرات الجزائرية في عهد الرئيس هواري بومدين، أوعبد السلام بلعيد وزير الصناعة والمناجم سابقا، هذا الأخير، يقول في كتابه "المصادفة والتاريخ" (Le hasard et l’histoire )، لقد كان بوتفليقة يطرح آراء واختيارات في المجال الاقتصادي وفي مجال التنمية الداخلية ثم في الميدان الدبلوماسي، توحي بأنه سيفرض اتجاها مخالفا لبومدين، ويضيف في فقرة أخرى، "بعد وفاة بومدين، شعر الكثيرون وأنا من بينهم بالتهديدات المحيقة باستمرارية السياسة المتبعة في عهده، وتجندوا من أجل سد طريق الخلافة في وجه عبد العزيز بوتفليقة الذي كانوا يرون فيه تجسيدا لكل ما هو ضد بومدين".
بتاريخ 8 يوليو/ تموز 1999 سيخرج بوتفليقة عن صمته، بعد أن عاد إلى سدة الحكم، وسيصرّح لمحطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1، قائلاً: "كان بإمكاني مسك السلطة بعد وفاة بومدين. لكن في الواقع الجيش نفّذ انقلاباً سلمياً، وفرض مرشحاً غير متوقع".
عملية الإطاحة ببوتفليقة، ستمسّ أسرته وبعض المقربين من الهواري بومدين أيضاً، بعد إجبار عائلته على مغادرة المنزل الذي كانوا يسكنونه، فيلا سيدي فرج، صادرها صهر الشاذلي بن جديد وزير الدفاع في تلك الفترة، ومنزل آخر في حي بيار في العاصمة الجزائرية. وكثير من الجزائريين يتذكرون تذمر والدة بوتفليقة وإخوته من ظلمهم.
اتهامه بالفساد المالي
سيواجه بوتفليقة بعد سنتين في المنفى موقفاً سلبياً آخر، استهدف هذه المرة ذمته المالية، ملفّ أشهره في وجهه مجلس المحاسبة الذي تشكل في عهد الشاذلي بن جديد، وجاء فيه أن بوتفليقة حوّل أمولاً للدولة لحسابه في بعض البنوك السويسرية، لكن بوتفليقة الذي كان دبلوماسياً كبيراً آنذاك - بين عامي 1965 و 1978 - طلب من القنصليات والسفارات الجزائرية دفع فوائضها على مرتين من حساباته الشخصية في سويسرا. وكان هدف الادعاء تشويه الوزير السابق إلى الأبد. وعلى عكس ما يقال أو يعتقده البعض، لم يكن عبد العزيز يملك ثروة طائلة خلال فترة إقامته في المنفى، حيث يقول أحد معارفه القدامى الذي كان يرافقه في باريس: "بالتأكيد كان أصدقاء عبد العزيز في فرنسا يدعمونه، لكنه كان بعيداً عن أن يصبح مليونيراً".
باريس، جنيف، أبو ظبي، فضلا عن عواصم خليجية أخرى، عاش بينها بوتفليقة إبان تجربة المنفى على مدار ستة سنوات، كان يؤدي خلالها بعض الاستشارات، نظرا لسعة خبرته واضطلاعه وقراءته الكثيرة. خبرته ومعارفه لا تقدر بثمن، وبناء على كفاءاته، سيشتغل مستشارا لدى السلطان الشيخ زايد أل نهيان في مجال العلاقات الدولية، غربية وأفريقية، كما عمل مستشارا لشركة "طوطال" العالمية، الشيء الذي وفر له مبالغ مالية محترمة.
وساهمت حنكته السياسية، في إدارة المفاوضات مع مدبري عملية فيينا الشهيرة، وهم الفلسطينيان، أنيس النقاش ووديع حداد، والأرجنتيني، إلييتش راميريز سانشيز، المعروف بكارلوس، وانتهت بالإفراج عن الرهائن، واللذين كان من ضمنهم وزير النفط السعودي أحمد زكي اليماني، وهو الجميل الذي لم تنساه السعودية لبوتفليقة، حيث كانت من بين الدول العربية التي تمنت أن تؤول إليه الرئاسة، نظرا لسمعته الدبلوماسية، كما أنها وفرت له إلى جانب والإمارات وأمريكا، حماية أمنية كي لا يتعرض للتصفية أو الاعتقال أثناء حله وترحاله، خاصة باريس، التي كان يمتلك بها شقة في الدائرة السادسة، وهي لا زالت في حوزته لحد الساعة. وتبقى زياراته السرية والقليلة إلى الجزائر في طي الكتمان، كما لا تتوفر معلومات كثيرة عن فترة منفاه في العاصمة السورية، إلا ما سبق وأن أورده موقع "آخر أخبار الجزائر"، الناطق بالفرنسية، والذي توقف عن الصدور، فإن بوتفليقة كان في ضيافة الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد، والذي خصص له شقة في دمشق، وراتباً شهرياً بالدولار.
الحياة كلها تعب
بقدر ما يتذكر بوتفليقة مرحلة المنفى، يستعيد بأسى لحظة إبعاده من دائرة الترشح للرئاسة، لكن مع ذلك يحس في قرارة نفسه أنه نجح ذهابا وإيابا، وجاء إلى قصر المرادية في وقته، لأن لديه فكرة خاصة عن الزمن، تجعله ينظر دائما إلى المدى البعيد، ومن المفارقات، ما زال الرجل الأكثر شهرة في الجزائر يشكل لغزا. رجل في سنه الثمانين ينتزع العهدة الرابعة من فوق كرسي متحرك، وتشهد حياة الرئيس السابع على تاريخ حافل ومأساوي في بعض الأحيان، تغذى بالمجد ولحظات الأزمة، الذل والمنفى، على مدار نصف القرن الماضي وهو لاعب رئيسي. من وجدة إلى الجزائر، عن طريق باريس، جنيف أو الإمارات خلال رحلته عبر الصحراء.
وبحلول الثاني من آذار/ مارس 2017 ، يكمل الساكن في قصر المرادية سن الثمانين، أعوام رسم خلالها سيرة ذاتية، تستدعي العودة إلى تاريخ صعود نجمه.
الرجل تعيد نشر حوار مع رجل الاعمال السعودي حسن عباس شربتلي قبل 22 عاما
تاريخ الصعود
حين ازداد بوتفليقة في 2 مارس، من سنة 1937 بمدينة وجدة، كانت المدينة في ذلك الوقت، موطنا لأغلب السكان المنحدرين من الجزائر. والده، أحمد، من مواليد نواحي تلمسان، غادرها في منتصف سنة 1930 لأسباب اقتصادية. توفي في عام 1958. والدته، المنصورية الغزلاوي، هي من رفعت من شأن عبد العزيز، لذلك ظل يكرس لها احتراما ومودة لا حدود لهما إلى اليوم، وبفضلها حافظت الأسرة على روابطها المتينة. جاء عبد العزيز إلى الحياة بعد ولادة المنصورية للابن البكر، وسيحمل اسم عبد القادر بن الأزعر، وهو الاسم الحقيقي المدوّن في السجل الرسمي لكناش الحالة المدنية في المغرب، وهو ما لا يعرفه الكثير من الناس .سيحمل الطفل عبد القادر، بعضاً من ملامح والده أحمد، زرقة العينين، والشعر الأشقر، لذلك سيطلق عليه اسم الأزعر، وهي تسمية كثيراً ما ينعت بها في شمال إفريقيا، الذين يمتلكون مثل هذه الأوصاف وهي بالمناسبة ليست سبة، كما سيحمل عبد العزيز بوتفليقة أيضا، اسم عبد القادر البالي، نسبة لأصول والده لقرية تحمل اسم أولاد البالي، وحين انتقل والده إلى مدينة وجدة، ليشتغل وكيلا بالسوق،سيتزوّج بسيدة مغربية كانت تسمى، ربيعة بلقايد، خلّفت له ثلاث بنات، هن، عائشة وآمنة وفاطمة. ثم اتخذ له زوجة ثانية، مغربية الأصل أيضاً، اسمها منصورية غزلاوي، رزق منها بعبد الغني، وعبد القادر (عبد العزيز بوتفليقة) ومصطفى، وسعيد، وعبد الرحيم، وزهور أو الزهراء، الذين سيحملون كباقي شقيقاتهم من زوجة والدهم اللقب العائلي، البالي، لكن اللقب الشعبي الأزعر، تغلب على الرسمي وحل محله في الأوراق الثبوتية.
في بيت العائلة
ها نحن في ضيافة بيت العائلة الحامل رقم 6 والكائن بزاوية حي ندرومة، طريق مولاي إسماعيل في مدينة وجدة، الذي كان معروفاً بساكنته الجزائرية؛ في هذا البيت كانت تقطن منصورية غزلاوي، وفيه ازداد عبد القادر الأزعر/ البالي/ عبد العزيز بوتفليقة، وما زال في ملكية عائلة بوتفليقة، ورُمّم بهدف تحويله إلى متحف، ويقع على مساحة241 متراً مربعاً.
غير بعيد عن البيت الأول، وتحديدا في زنقة محمد الريفي، يوجد بيت ربيعة بلقايد، الزوجة الأولى لأحمد البالي/ الأزعر، مساحته 91 متراً مربعاً. غير أن صغر مساحة هذا البيت، مقارنة ببيت الزوجة الثانية، لم يكن ليباعد بين العائلتين، حتى وإن كانت الأخيرة، هي المفضلة عند السيد أحمد، بل إنها ظلت محبوبة من طرف بنات ضرتها، وأبنائها من صلبها، فالكل كانوا ينادونها من باب الدلال والدلع، بـ"يايا" بدل ماما أو أمي، وساكنو الحيّ كذلك، لا يدعونها إلا بـ "يايا" .
أكيد أن عبد العزيز بوتفليقة ما زال يحتفظ، بأناتها، بنظراتها، بعزتها، بأفضالها عليه، ويردّد في دواخله وفي أحاديثه العائلية، كلما حضرت في السياق، بخفة لسان اسم "يايا"، كيف لا وهي من علمته الأناقة والاعتناء بمظهره، تسبل شعره منذ أن كان طفلاً، وتختار له أجمل هندام، هي من علمته اللباقة في الحديث، وحسن السلوك والمعاملة الحسنة، فضلاً عن أبجديات الحياة والمسؤولية تجاه الأسرة، والحفاظ على دفء العائلة ووحدتها، خاصة بعد وفاة الأب أواخر خمسينات القرن الماضي.
يايا" الام و علبة الأسرار
"يايا" سيدة تسكن روح عبد العزيز وقلبه، فهي من عبّدت له بداية طريق المغامرة النضالية والشهرة السياسية، لينتهي به الأمر، أطول رؤساء الجزائر حكماً.
أكيد أن عبد العزيز بوتفليقة ما زال يحتفظ، بأناتها، بنظراتها، بعزتها، بأفضالها عليه، ويردّد في دواخله وفي أحاديثه العائلية، كلما حضرت في السياق، بخفة لسان اسم "يايا"، كيف لا وهي من علمته الأناقة والاعتناء بمظهره، تسبل شعره منذ أن كان طفلاً، وتختار له أجمل هندام، هي من علمته اللباقة في الحديث، وحسن السلوك والمعاملة الحسنة، فضلاً عن أبجديات الحياة والمسؤولية تجاه الأسرة، والحفاظ على دفء العائلة ووحدتها، خاصة بعد وفاة الأب أواخر خمسينات القرن الماضي.
"يايا " سيرة امرأة
اشتغلت محاسبة في حمام شعبي في حي "ندرومة"، على مقربة من بيتها، تستخلص الواجبات من المستحمّات، ويحمل الحمام إلى يومنا هذا اسم "بوسيف"، نسبة لصاحبه، الذي كان صديقاً للعائلة؛ شخصية "يايا" والموقع الذي احتله في النسيج الاجتماعي على مستوى المهنة، جعل الاستعلامات التابعة للجنة التنظيمية العسكرية للمقاومة الجزائرية، التي كانت نشيطة على الحدود المغربية الجزائرية، تفطن لتوظيف والدة بوتفليقة في العمل ألاستخباراتي، ويعدّ هذا شرفاً لعائلة بوتفليقة.
" قاضي ناس الغرام"
كان بوتفليقة مولعاً في أيام المراهقة، بأغنية "يا قاضي ناس الغرام"، وبصاحبها المطرب الوجدي بن يونس بوشناق، المعروف محلياً بـ "فاندي"، التي ما زالت في أرشيف الإذاعة الجهوية لمدينة وجدة، يردد الأغنية وفي أحسن أحواله، حتى حين يدبر بعض المؤامرات بين أصدقائه في الثانوي، من باب الشغب والدعابة، أو في إطار استعادته لحالة وجدانية تعبّر عن هيامه وحبه، يوجهها بشكل استنكاري للممرضة، قولوا لها الممرضة يا "لال يا لا لال"، وهي أغنية جزائرية لرابح درياسة، يعرفها الرئيس بوتفليقة جيداً، لاسيما أنها تذكره بمحطة من محطات غرامه المعروفة، التي بات من بعدها رجلاً سرياً بعد سنة 1965، لا يعرف الناس شيئاً عن قصص حبه، إلا ما كتب عنه الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان، وما كتبته عنه المخابرات الفرنسية، بأنه زير نساء، عندما كان يأتي إلى فرنسا، وقيل إنه تزوج امرأة سويدية (خبر شائع كثيراً في السويد)، لكن المؤكد أن عبد العزيز بوتفليقة تزوج السيدة أمال التريدي، وهي طبيبة أعلى رتبة من الممرضة، مع فارق السن طبعاً بينهما، إذ يكبرها بنحو 50 سنة.
هذا وسبق لنور الدين بن شيكو، المدير السابق لجريدة "لوماتان" (الصباح)، أن أورد في كتاب له عن بوتفليقة، أن آخر عروض هذا الأخير للزواج، تقدم به إلى الصحفية اللبنانية جيزيل خوري، أرملة الزميل سمير قصير الذي اغتيل في سيارة ملغومة ببيروت.
أما عن علاقته مع السيدة آمال التريدي، الطبيبة السالفة الذكر، فإن زواجه منها كان شرعياً، وتم في حفل كبير وبحضور العائلة، وهي لاتزال على ذمته، وتقطن في باريس، وتتنقل كثيرا بينها وبين القاهرة، ومع أن هذه العلاقة أحيطت بالسرية على مدار سنوات، ويكاد يجهلها الجميع، فإن التريدي، تستفيد من وضعية زوجة رئيس دولة، بتوفّرها على امتيازات رئيس الجمهورية.
ويبقى التساؤل عن عدم ظهور التريدي مع بوتفليقة إلا مرة واحدة، رغم حضوره في المحافل الدولية واستقباله لرؤساء الدول؛ لا أحد يعلم الجواب، كي لا نظلم الرجل، فصديقه أحمد الذهبي الذي حرر عقد زواجهما، لا يدري، ويروي هذا الأخير لمصادر مقربة من مجلة "الرجل": "كنت كلما ذهبت إلى شقة الرئيس في حي "الأبيار"، لا أجد أمل، فأسأل عنها بوتفليقة، فيرد بأنها في بيته بالقصر أو عند عائلتها".
الرجل تعيد نشر حوار مع الرئيس اللبناني الراحل الياس الهرواي قبل 21 عاما
قبل الوداع
في العام 1962 ،وكان قبلها بعام قد حصل بوتفليقة على جواز سفر مغربي سنة1961، سلّمه له الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي كان وزيراً مكلفا الشؤونَ الإفريقية في حكومة ولي العهد الملك الراحل الحسن الثاني، ويُعدّ الخطيب كذلك، مؤسساً للجنة العليا المغربية الجزائرية للتنسيق بين مقاومتي البلدين.
كان الحصول على وثائق من هذا النوع، أمراً معمولاً به في تلك الفترة بين البلدان الخارجة لتوّها من ربقة الاستعمار، وحركات التحرر الوطني، لتسهيل تحرك المناضلين، ولم تكن هذه الخطوة من بوتفليقة تعبّر عن رغبته في الحصول على جنسية مغربية.
ودع بوتفليقة مدينة وجدة، إلى جانب رفاقه الذين عرفوا بمجموعة "وجدة"، واللذين شكلت لهم المدينة تربة انغراس للعمل الثوري، وقاعدة خلفية للمقاومة الجزائرية، وعبور السلاح، وزمناً من العمل والحركة، منحها ما يشبه صفة العاصمة الجزائرية، فضلاً عن أنها أرض الصبا والحب الأول، كما هو الحال بالنسبة لبوتفليقة، الذي تقاسم مع سكانها العيش، وتعرف فيها إلى أبرز الزعماء الأفارقة الذين حلوا فيها، في إطار التنسيق مع حركات التحرر الوطني المغربية والجزائرية، وعلى رأسهم الزعيم الجنوب إفريقي، نيلسون مانديلا، الذي زار المدينة بداية الستينات من القرن الماضي، بعد نزوله في الرباط، في إطار البحث عن الدعم والسلاح والتنسيق العسكري، وهي المطالب التي سهل عليه مهمّتها الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي كان كذلك صلة الوصل بينه وبين زعماء الجبهة.
لعل ثقل هذا التاريخ، الذي تنكر له عبد العزيز بوتفليقة، هو ما يجعل أصدقاءه في المدينة، اليوم، يعاتبونه على هذا الجحود، حتى وإن لم يعبر عن هذا التنكر صراحة، فإن موقع رئاسة الجمهورية لا يذكر مكان ازدياده، فضلاً عن أن الكثير من المنابر الإعلامية الجزائرية تشير إلى أن الرئيس ولد في تلمسان، في حين يقرّ المرحوم أحمد بن بلة أن والديه مغربيان. ربما كان الخوف من ردة فعل المؤسسة العسكرية، وهو التخوّف نفسه الذي كان حاضرا بعد وفاة "يايا"، عن عمر يناهز تسعين سنة، المنصورية الغزلاوي، كانت تمنّي النفس، في حياتها، أن يُهال عليها الثرى في المقبرة التاريخية سيدي المختار، إلى جانب والديها وأفراد عائلتها وضمنهم زوجها (توفي سنة 1958 )، وتحمّس عبد العزيز لتنفيذ الوصية، عكس شقيقه الأصغر وجل أفراد العائلة، الذين كان لهم رأي آخر، خوفاً على مصالحهم، وفقاً للاعتبارات المذكورة، كما لو كان الواقع الموجود أبدياً، ولا سبيل إلى تغييره. دُفنت "يايا" في إحدى المقابر نواحي الجزائر العاصمة عام 2009.
غادر بوتفليقة مدينة وجدة تلميذاً ومقاوماً، وعاد إليها سنة 1963، وهو وزير للخارجية، في عهد الحكومة الثانية لبن بلة، ليجتمع إلى نظيره المغربي، آنذاك، أحمد رضا كديرة، ويصدران بلاغا مشتركا يتعهدان فيه، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلديهما، وامتناع كل دولة عن الإضرار بالأخرى. وفي السنة ذاتها، كانت "يايا" على موعد مع مغادرة المدينة نحو الجزائر بصفة نهائية، ولم تعد إليها إلا في 31 أيلول / سبتمبر عام 1989، بصحبة ابنها عبد العزيز، بعد أن قطعا مركز " زوج بغال" الحدودي، وتردد بوتفليقة على كثير من الأماكن، التي ارتبطت بذاكرة طفولته و مراهقته بمسقط رأسه، ووصل الرحم مع كثير من أصدقائه وجيرانه وأقربائه، قبل أن يكمل الرحلة رفقة "يايا" نحو حامة مولاي يعقوب، نواحي مدينة فاس.